القارئ.. الناقد.. العالم
سعيد يقطين
أتذكر جيدا مقولة نطق بها الناقد والمترجم إبراهيم الخطيب، في أحد اللقاءات الثقافية لاتحاد كتاب المغرب مفادها: «عندنا قراء، وليس عندنا نقاد». وفي محاورتي مع فيصل دراج في كتاب دار الفكر (2003)، كتب: «عندنا نقاد، وليس عندنا نقد». وفي مختلف كتاباتي النقدية كنت أؤكد دائما: «عندنا نقاد، وليس عندنا علماء». نميز من خلال هذه الأقوال بين ثلاثة أصوات، أو فاعلين في علاقتهم بالنص الأدبي: القارئ، والناقد، والعالم. ورغم ما يمكن أن نلاحظه من خلال طباق: «عندنا، وليس عندنا»، من تعميم، لأن أي أحكام مثل هذه تنطلق مما هو مهيمن، فإنها مع ذلك تظل نسبية، وإن كانت دالة على ما هو سائد في التصور الذي يتأسس على معاينة واقعية للأشياء والظواهر.
عندما أطلق الخطيب قولته تلك في السبعينيات، كان النقد المغربي فعلا ما يزال في بداياته، وأن أغلب ممارسيه من الصحافيين والكتاب وبعض المثقفين. وكان الغالب على الممارسة الانطباع في النقاشات التي تتلو القراءات الشعرية والقصصية، أو ما كان يقدم في الملاحق الثقافية والمجلات، من قراءات سريعة ومقتضبة. كان كل الأكاديميين المغاربة وقتها مرتبطين بدراسة الأدب المغربي والأندلسي القديم، أو تحقيق النصوص. ولم يبدأ التمييز في واقعنا المغربي بين «النقد الصحافي»، و»النقد الأكاديمي» إلا في الثمانينيات عندما صارت الأجيال الجديدة تتقدم لمناقشة رسائل، أو أطاريح، يدور أغلبها حول الأدب الحديث، في مختلف أجناسه، عربيا ومغربيا. ولم يكن المقصود بالنقد الأكاديمي سوى ما يمارسه النقاد، الذين صار لهم موقع في الجامعة، أو من المثقفين الذين لهم مساهمات في متابعة المناهج النقدية، والتيارات الفكرية، التي في ضوئها كانوا يحللون القصيدة، والقصة القصيرة والرواية (إدريس الناقوري، نجيب العوفي، عبد القادر الشاوي). ومنذ الثمانينيات ستطلق صفة «الناقد» على كل من يشتغل بالأدب، قارئا ومحللا ومتابعا. وصارت كل المساهمات التحليلية للنص الأدبي، إلى الآن، تدخل في نطاق «النقد الأدبي»، وممارسها «الناقد الأدبي».
فهل ما قاله فيصل دراج، وهو يتحدث عن الناقد الأدبي العربي، يدرج الناقد المغربي أيضا، على اعتبار أنهم جميعا يشتغلون وفق تصور عام ومشترك، وينطلقون من رؤية موحدة في فهم الأدب والثقافة؟ وبذلك سنصبح أمام قولة عامة تنسحب على النقاد العرب جميعا، وتؤكد وجودهم في غياب «نقد» عربي جدير بهذه الصفة، وبترجمة قولة دراج على النقاد المغاربة، نؤكد في ضوء ما قدمنا، أن الناقد المغربي هو تطوير للقارئ، الذي كان في السبعينيات، حتى وهو يؤكد التحاقه بقافلة النقاد العرب منذ أن بدأ يفرض وجوده عربيا منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
في السياق نفسه، أذهب مذهبا آخر مختلفا في ما أتصوره بخصوص الممارسة النقدية الأدبية، مؤكدا أن عندنا نقادا ونقدا، ولكن ليس عندنا علماء، وبالتالي ليست عندنا «نظرية أدبية عربية». إنني أضع هذا التمييز في نطاق إيماني، ودفاعي عن الاشتغال بالعلم في دراسة الأدب، مفرقا بين «النقد الأدبي»، و»العلم الأدبي». وفي إطار انشغالي بالسرديات والتحليل السردي، وأمام التسونامي الذي عرفته الأبحاث الجامعية والدراسات العربية، التي تعنى بالسرد العربي قديمه وحديثه، تبين لي أن ما نمارسه يدخل في إطار «النقد السردي»، وليس في «التحليل السردي» (2012). إن الفرق بين «النقد» و»التحليل» يكمن في الإطار النظري الذي ننطلق منه في النظر والعمل. فالناقد يتعامل مع النظريات والمصطلحات التي يوظفها، من دون وضعها في إطار تصوري معين، صحيح أننا نراه يتعامل مع الأدب محاولا ادعاء «تأطيره» ضمن منهج معين (بنيوي، ثقافي..)، ولكن بالنظر إلى الطريقة التي يشتغل بها، يكتفي بتوظيف الأدوات التي يشغلها بصفتها «علبة أدوات»، خارج أي تصور أو إجراء علمي محدد. يبدو ذلك بجلاء في أنه يستدعي مصطلحات ومفاهيم وطرائق تحليل من السرديات، ومن السيميائيات السردية (وهما علمان مختلفان للسرد)، من دون منهج محدد، أو مقاصد معينة، على غرار ما يشتغل بها العلماء في الغرب لتطوير السرديات، أو السيميائيات السردية، من خلال توسيع دائرة المتون المشتغل بها، واستكشاف ما يسهم في توليد وتطور المصطلحات، والنظريات.
إن النقد السردي العربي، عكس التحليل السردي، لا يؤطره الاختصاص، وإن تعامل مع الاختصاصات الغربية بطريقة لا تراعي خصوصياتها. فيكون المزج بين النظريات المختلفة، ومحاولة توظيف المصطلحات المتباينة الدلالة، وإن كانت موحدة لغويا، من دون وضعها في سياق النظرية التي ولدت فيها، وهكذا. لم تتطور عندنا السرديات، ولا السيميائيات، ولم تظهر لدينا نظريات سردية يمكن أن نسهم بها في تطوير البحث السردي العالمي، وإن كنا نوظف مصطلحاتهما بطريقة تبسيطية. من القارئ إلى الناقد إلى العالم نحن أمام أصوات يختلف بعضها عن غيره. يتغير موقف القارئ بتغير موسوعيته، وذكائه في التعامل مع النص، وتأويله له بطريقته الخاصة. ويتغير موقف الناقد تبعا لما يتصيده من جديد النظريات الغربية، وإن ادعى مركزيتها وهيمنتها. لقد انتقل الناقد العربي من السوسيولوجيا إلى البنيوية فالدراسات الثقافية، باعتبارها «مناهج» أدبية. في الغرب حاليا، أي منذ عقدين من الزمان بدأ الحديث عن تطوير السرديات والسيميائيات، باعتبارهما علمين. إن العالم السردي في واقعنا هو القابل للتطور، لأن هذا هو مبدأ العلم. أما الناقد السردي فهو نتاج موجات ثقافية تعرف المد والجزر، ولا تتطور. وهذا هو واقع الدراسات الأدبية في كلياتنا. إنها ثانويات عامة، لا مراكز للبحث العلمي، وإنتاج المعرفة الأدبية.
كاتب مغربي

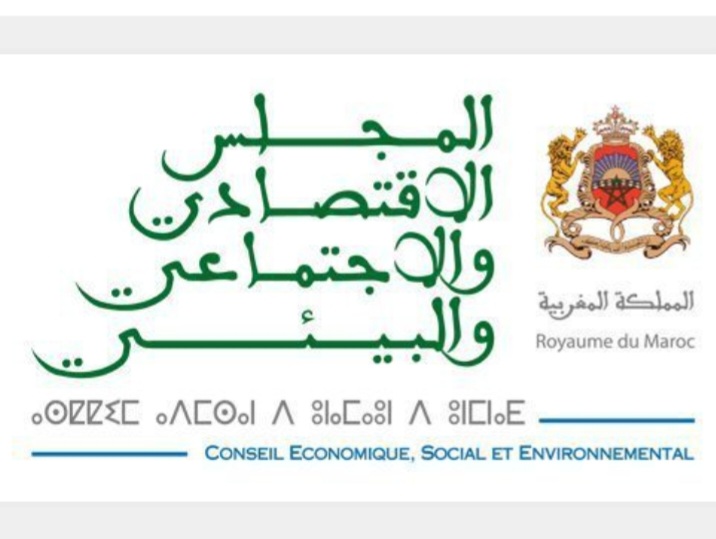


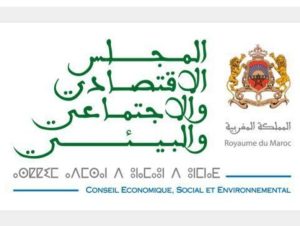









إرسال التعليق